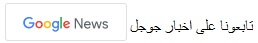بكر ابو بكر
ملف دراسة معمقة في ثلاث مباحث حول "إسرائيل" والنظام السياسي الفلسطيني، والانقلاب والإنقسام الفلسطيني، ثم مخاطر تسييس الانتخابات البلدية والقروية أوهيئات الحكم المحلية في فلسطين، وتعليق هام
مقدمة
ترمي هذه الدراسة إلى نقاش وتحليل المقاربة الإسرائيلية للنظام السياسي الفلسطيني، كما تهدف إلى الوقوف على واقع انقلاب "حماس" وما ولّده من الانقسام الفلسطيني ونتائجه ومخاطره التي لم تعد خافية على أحد وضرورة انهائه ، وكذلك مخاطر تسييس الانتخابات البلدية والقروية لهيئات الحكم المحلي في سياق المخطط الصهيوني لفرض نظام المعازل "الكانتونات" وفرض رؤيته لتصفية القضية الفلسطينية ورؤيته لإنهاء الصراع .ومما يمكننا عرضه من صلب هذه الورقة الثلاثية الهامة نقول:
أولا: في الحالة الفلسطينية، فإن المشروع الإستعماري الصهيوني ومن خلال مراجعة الخطاب(الإسرائيلي) فيما يتعلق ببنية وجوهر النظام السياسي الفلسطيني، لا يتجه نحو تفكيك الاستعمار في المستقبل بل يسعى الى إدامته بشكل او بآخر ، لأن نفي الشرط الاستعماري يتناقض مع جوهر المشروع الصهيوني، الذي يُمثل الإستيطان و الاحتلال العسكري أدواته المركزية، و إلى جانب الاستيطان/الاستعمار العمل على تجزئة الشعب الفلسطيني.
والى ذلك فإن الكيان الإسرائيلي لا يريد أن يتبلور نظام ديمقراطي فلسطينيي، حتى مع وجود الشرط الاستعماري ، و بالنسبة للتوجه الفكري، فإن ذلك يندرج ضمن تفكير إسرائيلي نمطي استعلائي (عنصري أبارتهايدي) على الثقافة العربية والإسلامية بشكل عام .
ثانيا: بنت دولة العدوان "إسرائيل"موقفها من الانقلاب الذي أفضى الى الانقسام على الركائز التالية:
1- إن بديل "حماس" في حكم القطاع سيكون ربما أكثر تطرفاً، وإن الفراغ الذي قد ينتج عن الإطاحة بها قد لا يكون محمود العواقب.
2-إن الانقسام الفلسطيني وما نتج عنه من وجود حكومتين منفصلتين هو مصلحة إسرائيلية كبرى، إذ إنه يعني تشتيت جهود بناء الدولة الفلسطينية.
3-إدارة العلاقة اليومية مع فصيل "حماس" في غزة، وإدارتها في الضفة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، دون الحاجة لتقديم تنازلات سياسية
4-لذا يصبح الصراع الفلسطيني الداخلي يشغل الفلسطينيين عن الصراع مع الاحتلال ويوجه جهودهم نحو التشتت و الصراع الداخلي، وبالتالي يتم ترحيل المطالب الفلسطينية بالاستقلال والحقوق السياسية إلى اجل غير مسمى
5-وعليه فإن سيطرة فصيل "حماس" على قطاع غزة تعني أن الرئيس محمود عباس ليس صاحب سيادة ولا سلطة على الجزء الثاني من الأرض ما يريح الإسرائيلي ويقوي خطابه. ويمكننا التفكر بأن "حماس" أصلًا لم تتقدم بمطالب سياسية خلال الصدام مع "إسرائيل"، فهي تطالب ضمن الخطوط العامة لأيديولوجيتها إعلاميا بإزالة "إسرائيل"، ورغم تبنيها في وثيقة الوفاق الوطني لفكرة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع مع حزيران
ثالثا: فيما يتعلق بالبلديات نرى هناك محاولات إسرائيلية لأن تشمل صلاحيات البلديات مهمة المدارس والتربية والتعليم وغيرها من الصلاحيات لتكريس سلطة المعازل (الكنتونات أوالباندوستونات...) ضمن أهداف الانتقاص من السلطة المركزية ممثلة في السلطة الوطنية الفلسطينية التي ما هي الا مدخل للدولة المستقلة، لذا على الجميع أن يتنبه لمخاطر هذا المخطط ضمن محاولات العدو والبعض المتساوق لإضفاء صبغة سياسية على انتخابات حكم الهيئات المحلية التي تكرس الادارة الذاتية وهو خطر يتهدد القضية الفلسطينية ضمن مسعى يقود لتصفية القضية الفلسطينية .
دعنا أيضًا نقول أن : هناك فهم خاطئ لدى البعض هو أن البلديات لعبت دور سياسي في القديم ، والصحيح أن البلديات أفشلت مشروع سياسي إسرائيلي لإيجاد البديل للتمثيل الفلسطيني عن منظمة التحرير الفلسطينية .
لذا فنحن نرى أن الرؤية الوطنية والإستراتيجية تتطلب عدم إقحام سلطات الحكم المحلي لصراع فصائلي وعدم إقحام سلطات الحكم المحلي لمحاصصة سياسية وبالإبقاء على مفهوم أن سلطات الحكم المحلي مفهومها خدماتي محض وفقط.
***
*إشراف أو قبول أو اعداد لجنة الدراسات السياسية في مركز الانطلاقة للدراسات المكونة من الأخوة بكر أبوبكر ، وعلي أبوحبلة ود.عبدالرحيم أبوجاموس وخالد غنّام، ومحمد قاروط أبورحمة ونجوى عودة ود.رائد الدبعي. (وهذه الدراسة بصيغتها الأولية من طرح الأستاذ علي أبوحبلة وأعادة بناء من قبل د.عبدالرحيم جاموس ثم تعديلات وتنقيحات الأخوة في اللجنة-فبراير 2022م)
مركز الانطلاقة للدراسات
فلسطين- 2022م
واليكم المباحث الثلاثة بالتفصيل
المبحث الأول "اسرائيل"والنظام السياسي الفلسطيني.
تحمل هذة الدراسة الكثير من التباينات، نظراً لتباين وجهات النظر الإسرائيلية حول بنية النظام الفلسطيني، ولكن تبقى غالبية المقاربات، مع بعض الاستثناءات القليلة، تفترض بقاء الشرط الاستعماري/الاحتلالي في التعاطي الإسرائيلي مع النظام السياسي الفلسطيني الحالي والمستقبلي.
هذا الشرط ليس أمراً مُسلّماً به في المقاربة الإسرائيلية، بمعنى أن وجود هذا الشرط لا يتعاطى مع المصالح السياسية والأمنية الإسرائيلية فحسب، وهي مصالح حركية (=ديناميكية) بطبيعتها، بل هي جوهر المشروع الصهيوني أيضاً، فغياب الشرط الاستعماري في كل مقاربة إسرائيلية للنظام السياسي الفلسطيني يعني غياب مركّب أساسي في طبيعة المشروع الصهيوني والصهيونية.
في قراءة معمقه لمجمل التعاطي الإسرائيلي مع النظام السياسي الفلسطيني الحالي والمستقبلي، توصلنا إلى نتيجة أن المقاربة الإسرائيلية لا يهمها في المقام الأول شكل وبنية وجوهر النظام السياسي الفلسطيني، ما دام السياق الاستعماري حاضراً في عمق الرؤية الاسرائيليه وعلى أطراف المشروع الوطني الفلسطيني، وبعدها تأتي في المقام الثاني المصالح السياسية والأمنية "لإسرائيل" في مقاربة كل نظام فلسطيني من حيث الشكل والمضمون.
كل نظام سياسي فلسطيني، لا سيما التعددي- الديمقراطي والوحدوي ، الذي يرتكز على شرعية الفلسطينيين، دون حضور الشرط الاستعماري الإسرائيلي، فإنه يعني تهديداً للمشروع الصهيوني. لذلك، ليس صدفة أنه عندما تعلو مقاربات إسرائيلية للنظام السياسي الفلسطيني خارج الشرط الاستعماري ومتحدية له، فإنه يتم طرح مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة، سواء في صيغة ثنائية القومية أو في صيغة دولة حرياتية (=ليبرالية)، أي دولة جميع مواطنيها. وهذه المقاربات الإسرائيلية للنظام السياسي الفلسطيني التي تستثني الشرط الاستعماري، تحتوي الأدبيات النظرية السياسية الكثير من التنظير حول النظام السياسي في المرحلة ما بعد الاستعمارية (=الكولونيالية)، ففي كثير من دول مرت بالمرحلة الكولونيالية، والعلاقة بين السياق الكولونيالي وإرثه السياسي، وبين النظام السياسي المتشكل للواقعين أو من وقعوا تحت الإحتلال و الاستعمار، ومواقف الدول الكولونيالية من النظم السياسية في مستعمراتها.
ميلا في دراسة رائدة للباحث السياسي "ميخائيل برنهارد" بعنوان “الإرث الكولونيالي الغربي على بقاء الديمقراطية”، يوضح أن الموروث الاستعماري/الكولونيالي يلعب دوراً كبيراً في تشظي (Fragmentation) مجتمع المُستعمرين سياسيّاً خلال الفترة الكولونيالية، ويستمر في ذلك عند محاولة تأسيس نظامهم السياسي.
وفي دراسة هامة أخرى (لماثيو لانغ) حول “الإرث الاستعماري والتطور السياسي”، يشير إلى الدور السلبي الذي لعبته القوى الكولونيالية الإستعمارية في هدم المؤسسات السياسية الديمقراطية للشعوب المستعمرة، ونقل السلطة منها إلى ما يسميه لانغ “local chiefs”، أي القيادات المحلية التي تسعى إلى ملء دور القيادات الوطنية السياسية ، هذا ما حدث مع الفلسطينيين في الداخل المحتل عام1948م ، ولاحقاً في المناطق المحتلة عام 1967.
من هنا فإن التنظيم السياسي الفلسطيني داخل الخط الأخضر لم يَسْلَم حتى الآن من تحديات السياق الكولونيالي الإستعماري الإسرائيلي، حتى في حالة المواطنة ، وفي دراسة أخرى (لماثيو لانغ)وآخرين بعنوان “فَرِّق تسد العالم” (Dividing and ruling the world)، يوضح من خلال دراسة إحصائية، وليس فقط تحليلية و كيفية، الدور الذي لعبته الدول الكولونيالية الإستعمارية في الحروب والصراعات الأهلية لدى الشعوب المستعمرة لحظة تأسيس نظمهم السياسية .
بعد كل ما سلف، لا بد من الإشارة إلى أن تطور النظام السياسي الفلسطيني في الحالة الإستعمارية الإسرائيلية مختلف عن السياقات الكولونيالية الأخرى السابقة له أواللاحقة في أمرين اثنين هما :
أولاً: في كون الأدبيات النظرية التي تطرقت إلى العلاقة بين نظرة المُستعمر والنظام السياسي للمُستعمرين خلال الاحتلال أو بعد الاحتلال، تطرقت في غالبيتها إلى أنماط كولونيالية غير استعمارية، فالكولونيالية الاستعمارية هي أكثر الحالات الكولونيالية تطرفاً في تعاطيها مع البنية السياسية للشعوب الواقعة تحت الاستعمار، فهي تهدمها أو تضعفها، أو تبقي تبعيتها لها.
والأمر الثاني : أن "إسرائيل" لا تنوي ولا تتوجه نحو نفي الشرط الاستعماري في فلسطين، ويبقى تعاطيها مع النظام السياسي الفلسطيني متعلقاً بالحفاظ على هذا الشرط، لإنهاء هذا الجزء، حريّ القول إن السياق الكولونيالي الإستعماري التاريخي ، لم يفضل نمطاً اونظاماً سياسيّاً معيناً، ولكن في جميع المشاريع الكولونيالية، تم نفي الشرط الاستعماري من خلال بناء النظام السياسي في المرحلة الوطنية (مرحلة الاستقلال)، مع بقاء تأثيره الثقافي على نخب المشروع الوطني.
في الحالة الفلسطينية، فإن المشروع الإستعماري الصهيوني ومن خلال مراجعة الخطاب(الإسرائيلي) فيما يتعلق ببنية وجوهر النظام السياسي الفلسطيني، لا يتجه نحو تفكيك الاستعمار في المستقبل بل يسعى الى إدامته بشكل او بآخر ، لأن نفي الشرط الاستعماري يتناقض مع جوهر المشروع الصهيوني، الذي يُمثل الإستيطان و الاحتلال العسكري أدواته المركزية، و إلى جانب الاستيطان/الاستعمار العمل على تجزئة الشعب الفلسطيني.
لذلك، فإن النظام السياسي الفلسطيني، من وجهة نظر المقاربات الإسرائيلية، عليه أن يتشكل ويتشابك من ذاته من جهة (العلاقات الداخلية بين الفاعلين السياسيين فيه) ومع "إسرائيل"من جهة اخرى، في إطار ديمومة الشرط الاستعماري ، و من الجهة المقابلة، فمن الواضح أنه في الحالة الفلسطينية، إن تأثر النخب الوطنية الفلسطينية بالمستعمر هو الأقل من بين مجموعة النخب الوطنية في العالم التي لم تتأثر بالمشروع الكولونيالي الإستعماري ونظامه وثقافته العنصرية .
أربعة شروط ومكونات للخطاب الصهيوني تجاه فلسطين والفلسطينيين
بتدقيق كل ما سلف من الناحية التطبيقية، فإن مراجعة الخطاب الإسرائيلي فيما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني تفترض بقاء الشرط الاستعماري في تطور النظام الفلسطيني وشكله النهائي، في ظل وجود أربعة مكونات هي : الحدود، والسيادة، والشعب، والنخبة السياسية، ومن يتمعن في هذه الركائز الأربعة ، يجد أنها ركائز دولة، وليست ركائز بنية نظام سياسي بالضرورة، رغم الارتباط العضوي والجوهري بينها من حيث الشكل والمضمون، ولكن لا تفهم "إسرائيل" النظام السياسي الفلسطيني خارج سؤال الدولة الفلسطينية، ومن هنا، فإنّ نقاش النظام السياسي الفلسطيني في سياق الشرط الاستعماري يطرح سؤال الدولة الفلسطينية التي تتخيلها "إسرائيل" وتسعى لها.
فيما يتعلق بالحدود، يحتاج النظام السياسي إلى حدود ثابتة تحدد سلطته وسيادته، ولا تتجه "إسرائيل" إلى ترسيم حدود ثابتة لكيان سياسي فلسطيني، فضلاً عن السيطرة على الحدود، وفي أحسن الأحوال، ستفرض "إسرائيل" معادلة التمييز بين الحدود الأمنية أو الآمنة والحدود السياسية، بحيث تكون السيطرة والفوقية للحدود الأمنية على الحدود السياسية .
أما في مسألة السيادة، في كل المقاربات الإسرائيلية للسيادة الفلسطينية، فإنها سيادة منقوصة، في كل المجالات تقريباً، ومؤخراً تحدث (رئيس الوزراء الإسرائيلي) "بينت" عن تأطير خاص لسيادة فلسطينية! وهنا نقول وتأكد (إن أي نظام سياسي لا يمكن أن يتطور بسيادة منقوصة مشوهة بشكل مزمن كالتي تقترحها "إسرائيل" ) ، و"إسرائيل" تدرك ذلك لأن سيادة كاملة تعني نفي الشرط الاستعماري عن المناطق المحتلة عام 1967.
وسيادة مشوهة ومريضة بشكل مزمن تعني بقاء الشرط الاستعماري. ببساطة، هذه هي المعادلة التي ترنوا لها دولة الإحتلال .
الشرط الثالث: فيما يتعلق بالشرط الثالث، وهو الشعب الفلسطيني، يمارس المشروع السياسي الإسرائيلي الفصل والعزل في الوقت ذاته تجاه المجموعات الفلسطينية (حتى داخل أراضي فلسطين العام 1948)، من خلال أدوات كثيرة منها: التشريعات القانونية، وإعطاء مكانة مختلفة لفلسطينيي القدس، ومشاريع الضم الجزئي والزاحف المختلفة، والحصار العسكري، والفصل السياسي، وتشير الأدبيات النظرية إلى أن عملية التجزئة للشعب الواقع تحت الاحتلال هي من أهم الأدوات لبقاء واستمرار الشرط الاستعماري، وكل نظام سياسي سيتطور سيكون مرتبكاً تجاه عملية الفصل والعزل للشعب، وتدرك "إسرائيل" ذلك، لذلك، كان الانقسام الفلسطيني مصلحة إسرائيلية إستراتيجية، وليس هنا المجال للتعمق في البعد الإستراتيجي الإسرائيلي من الانقسام.
الشرط الرابع :أما فيما يتعلق بالشرط الرابع، والمتعلق بالنخب الفلسطينية، من أحزاب وفصائل وقيادات وغيرها، تعتقد "إسرائيل" أن النخب الفلسطينية ككل النخب العربية لن تقوم ببناء نظام سياسي فلسطيني مستقر وتعددي، لا سيما الديمقراطي منه ، وينم هذ التوجه عن فكر إسرائيلي نمطي وعن نوع من التمني أو الأمنيات أيضاً، ، الكيان الإسرائيلي لا يريد أن يتبلور نظام ديمقراطي فلسطينيي، حتى مع وجود الشرط الاستعماري ، و بالنسبة للتوجه الفكري، فإن ذلك يندرج ضمن تفكير إسرائيلي نمطي استعلائي (عنصري أبارتهايدي) على الثقافة العربية والإسلامية بشكل عام .
والدليل على ما سلف ، في عام 1970 م ، نشرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بين صفوف الطلاب الإسرائيليين كتاباً من 40 صفحة بعنوان “دولة فلسطينية ديمقراطية: الوهم المصنوع”، وفيه سخرية من إمكانية بناء نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي!
تنطلق الرؤية الإسرائيلية من توجه يميز الدول الاستعمارية في تعاملها مع بنية النظام السياسي للمجتمع الواقع تحت الاستعمار، فمن جهة إن النظرة الاستعمارية الاستعلائية تنطلق من أن دولة المُستعمرين سوف تنتج نظاماً سياسيّاً يتماهى مع الدولة المستعمرة، ومن جهة أخرى في الحالة الإستعمارية الإسرائيلية تحديداً، تصطدم هذه الرؤية الإستعمارية التقليدية مع رؤية إسرائيلية تنطلق من أن الثقافة العربية والإسلامية لا تحتمل وجود نظام ديمقراطي في بُناها السياسية، فالثقافة العربية الإسلامية، كمنظومة ثقافية وفكرية وتاريخية، لا تنتج بنية سياسية ديمقراطية كما يتصورون، فكل تطور سياسي يكون بفضل "إسرائيل"! وكل إخفاق فلسطيني يعود للثقافة العربية الإسلامية.
المبحث الثاني: الانقلاب و الانقسام الفلسطيني .
بات الانقلاب المفضي للانقسام يمثل الركن الأساسي في التعامل مع السلطة الفلسطينية بالنسبة للكيان الصهيوني .
منذ الانقلاب الدموي -الذي أسمته "حماس" نفسها "الحسم العسكري"- أو التمرد و سيطرة فصيل “حماس” على قطاع غزة صيف العام 2007 م ، وما نتج عن هذا الانقلاب الدموي من الانقسام السياسي- الجغرافي في الحركة الوطنية الفلسطينية، تحول الانقسام إلى ركن أساسي في (سراطية =إستراتيجية "إسرائيل") تجاه الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، فمن جهة، أرادت "إسرائيل"الحفاظ على الانقسام الفلسطيني وتعزيزه وإدامته ، ومن جهة أخرى، أرادت إضعاف ما يشار لهما بطرفي الانقسام: أي فصيل "حماس" مقابل السلطة، الأول من خلال محاصرته اقتصاديّاً وجغرافيّاً، والثاني من خلال محاصرته سياسيّاً.
وبنت "إسرائيل"موقفها من الانقسام على الركائز التالية:
أولاً: إن بديل “حماس” سيكون ربما أكثر تطرفاً، وإن الفراغ الذي قد ينتج عن الإطاحة بـ”حماس” قد لا يكون محمود العواقب، ودائماً ما كان يتم ذكر المجموعات السلفية القتالية ذات الارتباطات العالمية كوريث محتمل لحماس في غزة ، وهي مقولة استمرت في الهيمنة على النقاش الإسرائيلي حول العلاقة مع “حماس” حتى العدوان والحرب على غزة عام 2014 م، في الجيش الصهيوني العدواني بتركيبته يقولون إن إسقاط نظام حماس سيقود إلى فوضى مثل الصومال، كما أنه لن يوجد ل"إسرائيل" البتة أي عنوان للردع أو لإجراء تسويات غير مباشرة ، وبالتالي فوجود “حماس” مهم من هذا الجانب بالنسبة للكيان الصهيوني .
ثانياً:إن الانقسام الفلسطيني وما نتج عنه من وجود حكومتين منفصلتين هو مصلحة إسرائيلية كبرى، إذ إنه يعني تشتيت جهود بناء الدولة الفلسطينية، بل إن هذه الدولة لم تعد ممكنة واقعيّاً في ظل وجود نظامين سياسيين مختلفين.
لذا فإن تعزيز حالة الانقسام تخدم الدعاية الإسرائيلية بأنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية على منطقتين منفصلتين. كما أنه يخلق مع الوقت سياقات سياسية ومؤسساتية تجعل من توحيد الأطر الإدارية والأمنية (وربما الاجتماعية-النفسية) فيهما أمراً مستحيلاً.
ثالثاً: تتوافق هذه الرؤية لواقع الإنقسام مع منطلقات الحكومات الاسرائيليه المختلفة بطرق شتى، فهي بالنسبة لرئيس الوزراء بينت تساعد في تحقيق مقاربته حول إدارة الصراع من خلال إدارة العلاقة اليومية مع “حماس” في غزة وإدارتها في الضفة مع السلطة الفلسطينية، دون الحاجة لتقديم تنازلات سياسية.
أما بالنسبة لبعض أركان الحكومة في أقصى اليمين، مثل "بينيت"، فإن غزة يجب أن تترك لمصيرها، إذ إن ما يهم هو الضفة الغربية، وتحديداً المناطق “ج” التي يجب العمل على ضمها ل"إسرائيل" ضمن خرافة أنها ما يسمونها زورًا "يهودا والسامرة".
رابعاً : يتعزز هذا التوجه الإسرائيلي، في حقيقة أن الصراع الفلسطيني الداخلي يشغل الفلسطينيين عن الصراع مع الاحتلال ويوجه جهودهم نحو التشتت و الصراع الداخلي، وبالتالي يتم ترحيل المطالب الفلسطينية بالاستقلال والحقوق السياسية إلى اجل غير مسمى، وعليه فقد دأب الاحتلال على تغذية هذا الصراع الفلسطيني-الفلسطيني ومعارضة أي تقارب فلسطيني داخلي واعتباره تهديداً للمصالح الإسرائيلية وإخلالاً بالتزامات السلطة الفلسطينية بالسلام، حيث كانت المفاضلة بين الصلح مع "إسرائيل" والتصالح مع حماس تتحكم بالكثير من مقولات الكيان الصهيوني وردات فعله على جهود المصالحة الفلسطينية.
خامساً : وربما الأهم من كل ذلك، أن سيطرة حماس على قطاع غزة تعني أن الرئيس محمود عباس ليس صاحب سيادة ولا سلطة على الجزء الثاني من الأرض التي يطالب باقامة دوله فلسطينيه مستقله عليها بحدود الرابع من حزيران للعامم 1967 ، بمعنى آخر، فهو ليس ذا صلة حين يتعلق الأمر بغزة، وهو لا يمكن له أن يطالب باستقلال على أرض لا يحكمها.
من هنا، فإن استمرار سيطرة فصيل حماس على غزة يعني تقويض المشروع الوطني الفلسطيني، وتقويض رواية ومطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس عباس بخصوص الدولة الفلسطينية .
لقد دأب السياسيون الإسرائيليون على استخدام هذه الإشارات حول عدم ولاية الرئيس عباس على غزة لتفنيد المطالب الفلسطينية خلال جولات المفاوضات المختلفة.
سادساً: ثمة حقيقة أساسية في ذلك، وهي أن حماس لم تتقدم بمطالب سياسية خلال الصدام مع الاحتلال، فهي تطالب ضمن الخطوط العامة لفكرانيتها (لأيديولوجيتها) إعلاميا بإزالة "إسرائيل"، ورغم تبنيها في وثيقة الوفاق الوطني لفكرة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع مع حزيران، إلا أنها لم تجعل هذا المطلب مركز سياستها واعلامها واشتباكها مع "إسرائيل" ، بل إن حقيقة ما تطالب به حماس عقب كل اشتباك وعدوان، لا يتعدى أن يكون مطالب إنسانية لتحسين ظروف الحياة في غزة، وتثبيت حكمها هناك، فمطالب حماس إنسانية وموجهة للغرب، وهي موجهة لتحسين حياة الناس، وهذا يمكن ل"إسرائيل" التعامل معه ويحقق غاياتها....ما يعني طرح عشرت الأسئلة؟ .
المبحث الثالث مخاطر تسييس الانتخابات المحلية .
بناء على ما تبين لنا في المبحثين السابقين وتنفيذ سياسات الإحتلال في ترسيح الانقلاب المفضي للإنقسام وتطبيق سياسات المعازل (الكانتونات) والمعازل البشرية على شعبنا الفلسطيني، وبناء عليه نقول: ابتعدوا عن تسييس الانتخابات لحكم الهيئات المحلية للمخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية
نعم. ابتعدوا أيها القوى والفصائل عن عملية تسييس الانتخابات لحكم الهيئات المحلية والبلديات وابقوا الانتخابات بمفهومها الخدماتي المحض وعدم اعطائها صفة التنافس السياسي ، حيث نجد هناك انعدام في الرؤيا السياسية للبعض الذي يحاول إضفاء صبغه سياسيه على الانتخابات المحلية الخدمية ، وهذا يعبر –برأينا-عن ضيق في الأفق السياسي للكثير من القوى المنافسة فيها .
الاحتلال الاسرائيلي ويشاركه في ذلك قوى دولية وإقليمية تسعى لإضفاء صبغة سياسية لانتخابات المجالس البلدية وحكم الهيئات المحلية ضمن سياسة تقود لتكريس المعازل (الكنتونات) وإضفاء صبغة سياسية على حكم الكنتونات من خلال البلديات وهذا مسعى تسعى إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتكريسه منذ زمن، ووفق رؤيتها لما يجب أن يؤول إليه نظام الحكم في فلسطين.
هناك محاولات إسرائيلية لأن تشمل صلاحيات البلديات مهمة المدارس والتربية والتعليم وغيرها من الصلاحيات لتكريس سلطة المعازل (الكنتونات أوالباندوستونات...) ضمن أهداف الانتقاص من السلطة المركزية ممثلة في السلطة الوطنية الفلسطينية التي ما هي الا مدخل للدولة المستقلة، لذا على الجميع أن يتنبّه لمخاطر هذا المخطط ضمن محاولات العدو والبعض المتساوق لإضفاء صبغة سياسية على انتخابات حكم الهيئات المحلية التي تكرّس الادارة الذاتية وهو خطر يتهدد القضية الفلسطينية ضمن مسعى يقود لتصفية القضية الفلسطينية .
لقد حاولت سلطات الاحتلال في انتخابات العام 1976م إضفاء صبغة سياسية لتمثيل سياسي لانتخاب حكم الهيئات المحلية لكن الوعي السياسي في تلك المرحلة ممثلا بالجبهة الوطنية ، الجبهة الوطنية العريضة التي مثلها وطنيون أحرار كانت لهم رؤيا وطنية وبُعد وطني وافشلوا مخطط سلطات الاحتلال في إيجاد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية وحافظوا على مفهوم البلديات الخدماتي المحض، نؤكدين أن الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) .
هناك فهم خاطئ لدى البعض هو أن البلديات لعبت دور سياسي ، والصحيح أن البلديات أفشلت مشروع سياسي إسرائيلي لإيجاد البديل للتمثيل الفلسطيني عن منظمة التحرير الفلسطينية .
نعيش اليوم مرحله سياسية خطيرة جدا في ظل حمى الصراعات الاقليميه التي يشهدها الإقليم و تشهدها سوريا واليمن ولبنان والعراق وهي من دعائم إسناد القضية الفلسطينية، وبتنا نخشى من هذا الوضع ومن هرولة بعض الدول العربية الانعزالية للتطبيع مع "إسرائيل" التوسعية العنصرية المهيمنة السياسة والأيديولوجيا، ومن محاولات سلطات الاحتلال للتفرد في فرض حلول مجتزأة على الشعب الفلسطيني، تمهد لتمرير المشروع الاستيطاني التهويدي وتكريس حكم المعازل (الكنتونات) التي تسعى له دولة الإحتلال .
نرى أن الرؤية الوطنية والإستراتجية تتطلب عدم إقحام سلطات الحكم المحلي لصراع فصائلي وعدم إقحام سلطات الحكم المحلي لمحاصصة سياسية وبالإبقاء على مفهوم أن سلطات الحكم المحلي مفهومها خدماتي محض وفقط.
إن حكم الهيئات البلدية والمحلية ومفهومها العام تقديم الخدمات،. وأصبح من الضروري العمل لتغيير معنى ومفهوم حكم الهيئات المحلية من المحاصصه الفصائليه وتحقيق المصالح الآنيه والشخصية وتوظيفها لتحقيق مصلحة حزبية أو عائلية وعشائرية إلى مفهوم يستند إلى تحقيق المصلحة العامه ورفع مستوى الأداء والقدرات والنهوض الاقتصادي وتحسين الموارد واستعمالها بالطرق الأمثل ضمن عملية الشراكة التي تجمع حكم البلديات وهيئات الحكم المحلي مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والخاص والمشاركة الفاعلة للمواطنين بما يحقق الصالح العام والمصلحة النفعية للمواطنين في سبيل تطوير الاقتصاد المحلي والنهوض بالأعباء المطلوبة لتطوير القدرات بما يضمن العمل للتخفيف من البطالة المستشرية والبطالة المقنعة المدمرة لمؤسساتنا بفعل التوظيف العشوائي .
إن الـبلدية أو الهيـئة المحلية هي وحدة البناء الاستراتيجي للسياسات العامة كما أنها وحـدة بلـورة هـذه السياسـات ووضع أسس تنفيذها، فهي تمثل العلاقة القوية بين الحكومة المركـزية والحكم المحلي في المحليات المختلفة ، كما أنها الوحدة التي تبلور حاجات السكان وتحدد أولوياته بناءً على أسس وقواعد تنموية دون إهمال للحاجات الطارئة التي قد تبرز بين الحيـن والآخـر ، وعلـيه فان البلدية أو الهيئة المحلية تمثل مصدر المعلومات والبيانات التي تكون أساسا لصياغة السياسات والأهداف الإستراتيجية للحكومة المركزية، كما أنها اللبنة التي تحقـق هذه الأهداف وتبلور هذه السياسات واقعا ملموسا في المجتمع المحلي،
ووفق هذا المفهوم فان الهيئات المحلية مفهومها خدماتي محض يجب أن يكون الأمر كذلك حتى لا نعطي أي مبرر لسلطات الاحتلال لتمرير مخططها في محاولات إضفاء بعد سياسي على الانتخابات ومحاولات تكريس الاداره الذاتية لتكريس سياسة الكونتونات
الخاتمة
ختاما نؤكد أن سلطات الإحتلال قد تعاملت مع قطاع غزة بُعيدَ الإنقلاب وما نتج عنه من انقسام بين غزة والضفة عام 2007 م ، كمسألة أمنية في البداية، وخاصة بعد الانفصال أحادي الجانب الذي قاده رئيس الوزراء السابق والارهابي "أريئيل شارون" عام 2005 م .
تطورت الرؤية لاحقاً لتكون غزة مسألة سياسية أيضاً. وهدفت خطة الانفصال الشارونية إلى تحييد قطاع غزة سياسيّاً وأمنيّاً عن حل قضايا الحل الدائم، ولا يستبعد أن شارون في قرارة نفسه كان يهدف من خطته أيضاً إلى فصل غزة عن الضفة الغربية كجزء من رؤيته للحل، الذي لم يكتمل بسبب مرضه وتنحيته عن السلطة. لاحقاً، وبعد سلسلة من الحروب التي أعقبت الانفصال الإسرائيلي الأحادي الجانب عام 2005م ، والانقسام الفلسطيني عام 2007 م ، وبعد صعود اليمين الإسرائيلي العنصري الأبارتهايدي الكاره للآخر للحكم عام 2009، بدأ اليمين ينظر إلى الانقسام الفلسطيني كفرصة سياسية ذهبية لتعزيز رؤيته للحل أو عدم الحل، فمن جهة، تقارع "إسرائيل" السلطة بكونها لا تمثل كل الفلسطينيين بسبب عدم سيطرتها على قطاع غزة، ومن جهة أخرى، ترفض أي مصالحة فلسطينية تؤدي إلى وحدة السلطة بين القطاع والضفة، بذريعة أن فصيل“حماس” هي حركة إرهابية.
لذلك، فإن الحروب التي شنتها "إسرائيل" -الدولة العدوانية بطبيعتها- على قطاع غزة (2008 وعام 2012 وعام 2014 ثم2021) ، لم تكن بهدف إسقاط حكم فصيل"حماس" الاسلاموي لقطاع غزة، وإنما لتعزيز و للحفاظ على الوضع القائم الذي رسمته "إسرائيل" وفق حاجتها ومصالحها، ويتمثل في ثلاث نقاط:
أولاً: تكريس الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ثانياً: الحفاظ على الهدوء الأمني في ظل الانقسام، وخاصة من غزة.
ثالثاً: الإبقاء على الحصار المفروض على قطاع غزة مع بقاء الانقسام والهدوء الأمني.
الإنقسام يبقى حاجة إسرائيلية، ونكبة كبرى فلسطينية لا بد من انهائه وإزالة آثاره .. كي يتفرغ الشعب الفلسطيني لمواجهة الإحتلال واجراءته الهادفه إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض رؤيته لنهاية الصراع.
تعليق الأستاذ خالد غنام من اللجنة
وصلتني دراسة بعنوان الإسرائيلي وتحطيم النظام السياسي الفلسطيني، وهي ورقة بحثية هامة جداً مقدمة من الأستاذ علي أبو حبلة ومراجعة الأستاذ عبد الرحيم الجاموس. وطلب مني الأخ بكر أبو بكر التعليق على فحواها ومحاولة إضافة دعائم علمية تحقق الهدف منها
أولاً: المبحث الأول "إسرائيل" والنظام السياسي الفلسطيني
• تحديد النظام السياسي الفلسطيني بأنه كل هيئة سياسية قادرة على إدارة شؤون الفلسطينيين وتمثيلهم في المحافل الدولية وهي منظمة التحرير الفلسطينية وما انبثق عنها من مؤسسات وهيئات تنفيذية وعلى رأسها السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك الهيئات التشريعية وعلى رأسهما المجلس الوطني الفلسطيني.
• إن ما تبحث عنه الحكومة الإسرائيلية هو تحويل السلطة الفلسطينية لمجرد إدارة مدنية تنفذ ما يريده جيش الاحتلال عبر التنسيق الأمني. أما المطلب الفلسطيني فهو رفع سقف العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية لجعلها علاقة سياسية تحتكم للمفاوضات السياسية التي تهدف لتحقيق المقررات الدولية وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها مدينة القدس (القدس الشرقية) وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
وهذين الموضوعين شائكين هما أساس النظام السياسي الفلسطيني، وإن الرجوع للخلف يعني تفتيت خيارات المستقبل، وما تقدم عليه الحكومة الإسرائيلية يسبب انتكاسة حقيقية لمستقبل السلام بالمنطقة برمتها، وإن الحديث عن تمزيق النظام الفلسطيني بين التحالفات الإقليمية والدولية والارتهان لمشاريع تفكيكية للمنطقة لن يكون بمصلحة شعوب ولكنه يحولها إلى دويلات ضعيفة متناحرة فيما بينها وفقاً للمشروع الامبريالي الهادف إلى استنزاف مقدرات الأمة العربية وتسعير الخلافات الإقليمية والنعرات الطائفية والعصبيات القبلية، وهذا السبب الحقيقي في انهيار النظام العربي، والنظام السياسي الفلسطيني جزء منه.
من جانب آخر تعتبر الأرض هي المعضلة الأساسية في الصراع العربي الصهيوني، وبالتالي لا يكون الهدف استعباد الشعب وسرقة ثرواته، بل أن الهدف هو التطهير العرقي وطرد الشعب عن وطنه وإحلال العصابات الصهيونية مكانه، وهذا الاستعمار الإحلالي يماثل ما حدث فيما يسمى بالعالم الجديد أي الأميركتين وأستراليا حيث قتل أغلب السكان الأصليين وتم محو حضارتهم، مع إحلال المستوطنين الأوروبيين مكانهم. لذا يكون الهدف الحقيقي للنظام السياسي العربي الفلسطيني الحفاظ قدر الإمكان على ملكية الأرض وذلك عن طريق تعزيز طرق استثمارها وتبيان للمجتمع الدولي أن السيادة على الأرض الفلسطينية لا يمكن أن تنتقل لأي دولة أخرى إذا ما تم شراؤها من ملاكين أجانب، وأن الصندوق القومي اليهودي الذي يدعي ملكية الأرض الفلسطينية كلها هو عبارة عن مؤسسة استعمارية يتناقض عملها والقانون الدولي.
إن الثورة الفلسطينية انطلقت من أجل تحرير الأرض الفلسطينية وهو هدفها الوحيد، ولم تكن الضفة الغربية وقطاع غزة خاضعة لاحتلال، وفي ذلك الوقت لم تشارك الثورة الفلسطينية الأنظمة العربية في إدارة شؤون الفلسطينيين، لإن هدفها هو تحرير الأرض المسلوبة، ومن هنا يكون أساس تكون النظام السياسي الفلسطيني قائم على تحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال الصهيوني. وقد تم تقديم الأرض على باقي مكونات النظام السياسي على اعتبار أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يمتلك السيادة على أرضه قبل تحريرها، أما موضوعة الولاء السياسي للشعب الفلسطيني فهو كان ومازال محدد بقدرة النظام السياسي بالدفاع عن الأرض الفلسطينية بكل الطرق النضالية المتاحة.
أما إطار الحديث عن تفكيك المجتمع الفلسطيني فيبدأ من دراسة العناصر المكونة للحمة الوطنية الجامعة وهي المشكل الحقيقي للنظام السياسي الفلسطيني، فأكثر ما يجمع عليه الشعب الفلسطيني قدسية الأرض وإن بيعها للصهاينة جريمة لابد أن يتم إعدام أو محاكمة من يقوم بذلك، وإن تسلل الأراضي للصهاينة بطرق ملتوية لكنه يكون أحياناً برضى بعض الفلسطينيين، وعلى النظام السياسي الفلسطيني أن يكون صارماً بالتعامل مع هذه القضايا. وهذا يجرنا لحرمة الدم الفلسطيني ونبذ الاقتتال الداخلي، والحقيقة أن تطهير الدم الفاسد من المجتمع الثوري هو الأساسي الحقيقي لاستمرار الثورة، فالنضال الفلسطيني محارب من أطراف عديدة تحاول زرع الفتن داخله ولابد أن تكون عملية التطهير صارمة، أما النقطة الأهم أن فلسطين هي ضمير الأمة العربية ولا يمكن أن يكون نظامها السياسي بعيد عن نبض الشارع العربي ويتفاعل مع همومه ومشاكله دون أن يتدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، بل من خلال التضامن الشعبي والتلاحم القومي، وإن التجاذبات الإقليمية تجتمع على ضرورة استمرار النضال الفلسطيني.
المبحث الثاني الانقلاب والانقسام
هذا الوجع الفلسطيني من جرح غائر لا يمكن أن نتعامل معه بكلمات بسيطة، فبينما نرى أن الانقسام السياسي يشكل أكبر ورقة ضغط على النظام السياسي الفلسطيني ويحاول الكثيرون سحب شرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لكل الشعب الفلسطيني، إلا أننا نشهد بكل عدوان على قطاع غزة تعاظم التعاطف الشعبي الفلسطيني حتى أن شوارع القدس والخليل ونابلس كانت تردد: يا للي بتهتف للانقسام فتح بتهتف للقسام، في حقيقة سياسية لا يمكن تغافلها أن هناك قواسم مشتركة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح وحماس وهذه القواسم المشتركة كثيرة بل أن تطابق الفعلي بينهما تجعلها من الناحية الثورية الأقرب بين التنظيمات الفلسطينية التي باتت المسافة بينهم وبين قدرتهما الفعلية على تحقيق مشروعهم السياسي بعيدة جداً.
إلا أن أزمة حركة حماس الحقيقية هي تركيز نجاحها بالعمل العسكري بطريقة مستبدة ترفض معه حق التنظيمات الأخرى بامتلاك أي قدرات عسكرية إلا بإذنها وأنها هي صاحبة الحق بإعلان التصعيد القتالي وكذلك إنهاؤه دون الرجوع للفصائل الأخرى. وهذا الاستبداد في الرأي يجعلها ترفض أي تغيير قد يسبب تراجع قدرتها بالإدارة قطاع غزة من الناحية العسكرية. أما إدارة شؤون السلطة فهي تسببت بترهل النظم والقوانين وتراجع مستوى كفاءة المؤسسات وترسيخ الفصائلية في التعيينات، وأن التكيف مع حالة الحصار أدى إلى انهيار رأس المال الاجتماعي في قطاع غزة مع بروز طبقة متنفذة لها صلاحيات كبيرة وخصوصاً بالتعامل مع التجار المصريين والإسرائيليين والمنظمات الغير حكومية، وأنها باتت قادرة على الحفاظ على حصتها بالسوق حتى لو سقط حكم حماس.
إلا أن الحقيقة السياسية تؤكد أن النظام السياسي بحاجة إلى قوة الضبط التي تنفذها الأجهزة الأمنية وهي القادرة على حماية التجمعات الفلسطينية من كل الأخطار، وعلى رأسها عدوان جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، وكذلك الفلتان الأمني الذي تسببه عصابات التجارة الممنوعة، وكذلك التعامل مع المعارضة السياسية بالطرق القانونية، وأخيراً تنظيم طرق المواجهة مع جيش الاحتلال وقطاع المستوطنين. وهذه الحقيقة لابد أن تلتزم بها الفصائل كافة في شطري الوطن وإلا فإن تبرير فعل نضالي بالخليل ومنع نظيره بغزة يعني أن الأجهزة الأمنية ليست إلا أذرع عسكرية للفصائل.
المبحث الثالث تسيس الانتخابات المحلية
وجد البعض في الانتخابات المحلية حلبة صراع عشائري زاد من حدة التوتر بين الوجاهات العشائرية وبين أن هناك ضرورة حقيقية على تحديد أهداف الحقيقية من العملية الانتخابية والخطوات التمهيدية السابقة لها، فالعمل الديموقراطي يبدأ قبل الانتخابات من خلال بناء خطة عمل تهدف إلى تحسين أداء عمل البلدية أو السلطة الإدارية وذلك من خلال دراسة الخطط المقدمة واستشارة ذوي الاختصاص والمراكز البحثية وبعد ذلك المصادقة على الخطة وعرضها على الأطر التنظيمية وإبداء الملاحظات عليها وتنقيحها لتصبح خطة عمل للسلطة الإدارية التي يتبناها التنظيم بعد المصادقة عليها من الأطر التنظيمية العليا، ثم يتم ترشيح أسماء الأشخاص القادرين على تنفيذها، ويتم طرح هذه الأسماء على الأطر التنظيمية وبعد ذلك يتم عرضها على ذوي النفوذ الاجتماعي والإداري واستشفاف رأي الفئة المستهدفة لبناء التحالفات مع القوائم الأخرى.
هذا التمرين الديموقراطي يعزز بناء المجتمع الديموقراطي ويهدف بالأساس لإشراك الشعب بإدارة شؤونه الداخلية وهو الهدف الأساسي للنظام السياسي والسبيل الحقيقي لفهم تطور الفكر السياسي للتنظيمات السياسية وقدرتها على تحقيق طموحات قواعدها الشعبية، وإن الهروب من الاستحقاق الانتخابي هو هروب من مواجهة الجماهير، وإن عملية تطوير المجتمع تستند إلى أهلية من يقود السلطات المحلية ويعمل وفق خطة عمل لها شرعية تستند على صندوق الاقتراع الديموقراطي، ولا يوجد أي مبرر يمنع الانتخابات، فالثورة الفلسطينية كانت تمارس الفعل الديموقراطي في أصعب الظروف النضالية في أثناء المواجهات المسلحة وفي سجون الاحتلال وفي الشتات الصعب، تبقى الانتخابات هي الفيصل النهائي لمشروعية التمثيل السياسي ومطابقة القرار السياسي للرغبات الشعبية.
انتهى
إشراف أو قبول أو اعداد لجنة الدراسات السياسية في مركز الانطلاقة للدراسات المكونة من الأخوة بكر أبوبكر وعلي أبوحبلة ود.عبدالرحيم أبوجاموس وخالد غنّام، ومحمد قاروط أبورحمة ونجوى عودة ود.رائد الدبعي. (وهذه الدراسة بصيغتها الأولية من طرح الأستاذ علي أبوحبلة وأعادة بناء من قبل د.عبدالرحيم جاموس ثم تعديلات وتنقيحات وتعليقات الأخوة في اللجنة-فبراير 2022م).