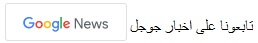بقلم د. مصطفى الشاوي
لا مراء في أن الشعر كائن فني يسكن الذات الشاعرة ويتملكها من حيث لا تدري، فيغدو مع كثير من الشعراء ضربا من السحر أو الجنون، وعند آخرين انبثاقا من انبثاقات الوعي الشقي أو الاستبطان المعرفي، فمع أولئك تصبح الكتابة الشعرية كالنقش على الحجر باستغوار الذات والحفر في مكوناتها الجينية التي راكمها الزمن المرُّ فأصبحت كهشيم المحتظر، ومع هؤلاء تمسي الكتابة كالرسم على الهواء والرقص في الأفق والنقش على الشفق للقبض على المنفلت في الزمان والمكان، باستبصار رؤى شعرية توقا إلى الخلاص مما هو كائن عبر تشكيل الممكن.
استنادا إلى هذا المعطى القبلي، والتوقع الافتراضي، نقرأ ديوان (طَعناتٌ في ظَهْرِ الْهَواءْ) للشاعر محمد بلمو، رغبة منا في النبش في تربة النص الشعري للكشف من خلاله عن جذوره الدلالية الخفية وطريقة تشكيل طبقاته التكوينية المركبة ليست تلك التي يصدر عنها الشاعر فحسب وإنما تلك التي تتحكم في النص الشعري وتؤطر نظامه اللغوي دلاليا وتأويليا، ونفترض منذ البدء أن يصدر مدلول النص الشعري عنده عن التنافر المعرفي الدلالي الذي يجعل الشاعر نفسه متأرجحا بين الرأي والرأي الآخر، وبين الشيء وضده، على مستويات تكوينية شعرية مختلفة ومتعددة، نقف في هذه المقاربة عند أهمها، ويصاحبنا سؤال أساسي، كيف يحقق النص الشعري في ضوء التنافر الدلالي والمعرفي انسجامه وتناسقه.
فبدءا من العنوان بإمكان القارئ أن يؤسس لفكرة التنافر الدلالي الذي يؤطر النظام الفني لقصائد الديوان ويؤثث الرؤيا الشعرية التي يصدر عنها الشاعر محمد بلمو في مختلف نصوصه الشعرية، إذ يدل العنوان على الفعل (طعنات) وحالة الفعل، فالفعل هو الطعن الذي من سمته الغدر، وهو فعل إجرائي مقصود في ذاته وملموس لأنه سلوك ماكر لا يمكن لمن ارتكبه أن ينكره، ولأن كثيرا من الدلائل تدل عليه، و تؤكد حالة وقوع الفعل (في ظهر الهواء) هذا الاجراء من خلال مدلولها التنافري، ذلك أن فعل الطعن كان عبثيا، إذ وقع في الظهر، أي من دبر وليس من قبل، ثم إن الظهر ظهر هواء، كناية على الهشاشة والرهافة من جهة، وعلى لا جدوى الطعنة من جهة أخرى، إذ لا إيلام لطعن الهواء.
ويجمع العنوان بين المحسوس والملموس، وبين المرئي واللامرئي، وبين القصدي واللاقصدي، وهو ما يؤكد فرضية احتكام نصوص الديوان إلى التنافر الدلالي، مع العلم أن مفردات العنوان تبقى مفتوحة على تأويلات متعددة، فقد تدل لفظة (الهواء) على الذات الشاعرة، وقد تدل (طعنات) على ما عاناه الشاعر ويعانيه من إيلام وآلام مادية ومعنوية، كما قد تدل لفظة (الهواء)على الوطن و(طعنات) على توالي الخيبات والأزمات والنكبات. والطعنات بصيغة الجمع والتنكير تدل على الانفتاح والتعدد، فالطعنة طعنات؛ طعنة الموت المفاجئ، طعنة الغدر، طعنة الظلم والجور، طعنة الصديق والرفيق، طعنة الجهل والتخلف، طعنة الاقصاء والتهميش. يقول الشاعر:
يا صَبْرَ الْجِبالِ/ أيْنَ أجِدُ كوخاً/ وَوِسادَةً وَرَغيفا لِصَبْري/ الْأبَدي/ السَّرْمَدي/ والطّعَناتُ السَّحيقَة/ تَتَوالى على هَوائي/ تَقْتاتُ مِنْ ألَمي/ تَنْتَعِلُ شَقائي/ كَيْ تَنْتَشي.
إذا كان التنافر المعرفي dissonance Cognitive في علم النفس، هو حالة من التوتر أو الإجهاد العقلي أو عدم الراحة التي يعاني منها الفرد الذي يحمل اثنين أو أكثر من المعتقدات أو الأفكار أو القيم فإن التنافر الدلالي وجه من أوجهه تجلياته، لكن ما يهمنا ها هنا هو ربطه بالنص الشعري لنتبين كيف سعى الشاعر إلى خلق حالة من الاتساق الفني رغم تعدد مظاهر التنافر نصيا وفكريا وجماليا. مع العلم أن التنافر الدلالي في الشعر مظهر من مظاهر شعرية النص ولا يتحقق له ذلك إلا بتوفر مكونات أخر، تدعمه وتبرره وتمنحه شعريته دالا ومدلولا. ومعلوم أن فصاحة الكلام خلوصُه من تنافر كلماته، ومن ضعف التأليف والتعقيد اللفظي والمعنوي. ولكي لنبرهن على كون الشاعر يصدر عن فكرة التنافر الدلالي، ويقوم على الشيء الذي يؤمن به (الحياة) وضده الذي يهيمن على الواقع (الموت) يمكن أن نميز على الأقل بين ثلاثة مظاهر تنافرية تهيمن على نصوص الديوان. وهي على التوالي: الكتابة والمحو/ الوجود والعدم/ الإثبات والنفي.
التنافر النصي/ الكتابة والمحو:
تختلف طقوس الكتابة فتنعكس على النصوص الشعرية بحسب طبيعة الفضاء الذي يؤطر فعل الكتابة في الزمان والمكان وعلى الرغم من الاختلاف المؤشر عليه على هذا المستوى فإن نصوص الديوان سعت إلى تحقيق الانسجام على مستوى الرؤيا الفنية والفكرية ذلك أن ما يجمع بينها أكثر مما يفرق.
ويشتغل الشاعر محمد بلمو على عناوين دواوينه الشعرية فينحتها نحتا جميلا، وبشكل مدروس ليجعلها عتبة لا مناص للقارئ من الوقوف عندها وقفة تأملية عميقة ليكتشف الخيوط الرابطة لملفوظها والناظمة لمنطوقها، ويستطيع إدراك المدلول العام لمختلف نصوص الديوان.
نقصد بالتنافر النصي بين الكتابة والمحو في مستواها الأول اختلاف الكتابة الشعرية من حيث كونها تنأى عن النمطية وتسعى إلى توزيع سواد الكتابة على بياض الورق بشكل وظيفي. فيغدو النص الشعري علامة دالة قلبا وقالبا على مواقف الشاعر ورؤاه، وهي بذلك دليل مادي وبرهان حجاجي يقاوم الاندثار والمحو والاقصاء، ويقف النص الشعري في وجه كل من يمارس هذه الأفعال المشينة، أو يدعو إليها. ويجسد فعل الكتابة - كإجراء دال ذي بعد رمزي - أكبر حجة يسعى الشاعر في ضوئها إلى إثبات كينونته الروحية ووجوده المادي الذي يهدده المحو. يقول:
في بَهْوِ اللّغَةِ/ أشْياءٌ تَتَزاحَمْ/ تَقْضِمُ أصابِعَ الْكِتابَةْ.
وما دامت أرض الواقع قاحلة، واستنبات مشاتل المعنى - لضخ كميات كافية من الأكسجين لإنعاش رئة النص الشعري - أمرا عسيرا ومطلبا صعبا فإن الرقص على مساحات السواد يظل الحلمَ الأرجحَ، ويمسي الركض على إيقاع الشك التوْقَ الأصحَّ، وتُضحي سنفونية البكاء في زمن الغياب على وهج الحروف مقاما من مقامات الشجن. وفي ضوء هذا تضطرب طقوس الكتابة فتصطدم بصخرة الواقع، وتتأجج المشاعر بين الحنين والأنين، فتنعكس على مرآة الذات الشاعرة الراغبة في الخلاص. وعلى الرغم من هذا لا يبزغ فجر الرؤى إلا لماما مع بصيص من الضوء يهدده السواد. فتأتي القصيدة متأرجحة بين أصوات متنافرة ترصد الذي جرى؛ صوت راعد في وجه الظلام والغفلة والجوقة وكاشف عن مساحات الصمت. وصوت واعد خافت تائق نحو الانعتاق والأمل والوجود والحياة.
جَرى الّذي جَرى/ جَرى الطَّمْيُ فَوْقَ الْجِسْرِ/ واخْتَفى الْماءُ الْعَذْبُ/ تَحْتَ الثَّرى/ جَرى الذي جَرى/ يَئِسَ السَّحَرَةُ مِنْ سِحْرِهِمْ/ واشْتَكى الْمُتَسَلِّطونَ مِنْ رَقْصَةِ القُرى.
فبدءا من أول قصيدة في الديوان تطرح إشكالية استنبات مشاتل المعنى في تربة النص الشعري، فتصور الذات الشاعرة نفسها مأسورة ومكبلَة ومغتربة، يتجلى ذلك من خلال مقاطع النص الشعري التي جاءت على شكل (هَمْهَمات) يحس معها القارئ بنوع من الدهشة تعتري الشاعر، وهو في مقام بين بوابة الولوج إلى عالم البوح، أو المكوث خلف بوابة الصمت، أي بين الإيمان بالفعل، والرغبة في الفعل، والنتيجة جراء الفعل:
قَصيدَةٌ تَلْهو بِأصابِعي/ بِأعْصابي تَلْعَبُ الْحُروفُ/ والْكَلِماتْ/ السُّرْعَةُ الّتي تَتَحَرَّكُ بِها الْأشْياءُ/ لا تُثيرُ أحَداً/ بَطيئَةٌ جدّاً/ لَكِنَّها صاعِقَة.
إذا كان التنافر المعرفي والدلالي في معناه المبسط أن تكون الكلمة متعارضة مع الكلمة الأخرى، أي أنَّ إثباتَ شيء معين نفيٌ لأشياء أخر، فإنه لا ينشأ على مستوى اللغة والأسلوب إلا عبر تقنيات فنية يجمعها الانزياح الدلالي، والإضافي، والتركيبي، والاسنادي، والاستعاري. وليس بخفي أن الانزياح أسلوب بلاغي يعبر به الشاعر إلى عالم الخيال، ويرمم به انشطاره الاجتماعي، بين عالمين متناقضين، ويجبر به انكساره النفسي، ويعْبُر به ومعه إلى العالم الشعري المتخيل، باعتباره المركب الوحيد الموصل إلى شط النجاة - وما هو ببالغه- والكاشف عن الحقيقة المرة:
وأنْتَ تَلْتَحِفُ الظّلَّ/ تَسْقيهِ مِنْ قِنّينَةِ عَطَشِكْ/ أسْلَمْتَ انْزِياحَكَ لِشَراسَةِ الْمَكانْ/ لَعَلَّ سِرَّ هَذا الْجُنونِ يُميطُ اللّثامْ.
ومن مظاهر التنافر الدلالي على مستوى شكل الكتابة الشعرية عند الشاعر محمد بلمو نفي السكون للحركة. ومعلوم أن السكون من الناحية النُّطقية هو عدمٌ، أو غيابٌ لأيِّ تحريكٍ، ويُرمَز له في مستوى الخط أو الكتابة بدائرة صغيرة ملحقة بالحرف، مثلُه مثلُ الحركات، وأما من الناحية الوظيفيَّة، فله أثرٌ في اختلاف أبنية الكلمات ودلالاتها، واختلاف المقاطع. ويبرز ذلك بدءا من متوالية العنوان، حيث جاء حرفها الأخير ساكنا (طعنات في ظهر الهواءْ)، وقد سارت على منواله جل عناوين النصوص الشعرية، مما يشكل ظاهرة ملفتة لاهتمام القارئ، وتكشف عن طبيعة نمط الكتابة عند الشاعر محمد بلمو، وعن نفسية مأزومة وذات مكلومة وأصوات محسورة. سواء كانت سواكن أصلية وهي القليلة، أو طارئة وهي المهيمنة على الديوان.
وهذا ما يؤكد فرضية كون الذات الشاعرة تكتب وتَنْكتب في آن واحد؛ فهي صفحة بيضاء يشكلها فعل الكتابة، لا وفق ما ينبغي أن تكون بل وفق ما أملته وتمليه الظروف، وسطرته الأحداث وفرضته الاكراهات، كما تشكل جزءا من هذا الاكراه، ما دام الشاعر عاجزا عن السيطرة على الفعل في ذاته وفي غيره، بحيث تصبح الكتابة حجة على الشاعر لا له فحسب، ومن خلالها نتعرف على مضمرات الذات وهواجسها ولا شعورها، لتصبح الكتابة بموجب ذلك مرادفة للاّكتابة واحتمالا ممكنا من ممكنات الوجود. وفي هذا السياق لا يتوانى الشاعر في توظيف صفات تنافرية كما يتجلى بوضوح في كثير من النصوص من نص (ستفاجئكم) حيث نجد الشاعر يثبت الصفة وينفيها في نفس الآن (وحيد ≠ لست وحيدا)، (المتردد ≠ المتمرد)، يقول:
واحدٌ/ لسْتَ وحيدًا/ أيُّها الْمُتَعَدِّدُ/ الْمُتَرَدِّدُ/ الْمُتَمَرِّدُ/ الْمُتَشَرِّدُ/ سَتُفاجِئُهُمْ.
ومع الشاعر، يعيش قارئ الديوان تفاعلات البحث عن المعاني المضمرة، وراء تضاريس النصوص الشعرية الضاربة في التشكيل وفق رؤى مختلفة، وتشكلات أحداث مختلة، ووقائع طائشة زاغت عن معناها القيمي. وتبرز إرهاصات التنافر المعرفي بين مبادئ آمن ويؤمن بها الشاعر، وواقع يكذّبها، وعالم يرفضها، وإنسان يحاربها، فتظل أحلاما مرجأة وآمالا منتظرة، قد تأتي أو لا تأتي. ويحس القارئ بالشاعر- وهو يسعى إلى أن يجعل من القصيد ترياقا- يسقي الجراح بدمه ودمعه وحبره، لكن تحقّقَ هذا الأمر صعبٌ، حتى وإن غدا الشعر سلاحا أو بوحا شفيفا، يكشف عما توارى من جراحات وأشجان، وتصبح القصيدة ذاتها كائنا يتغذى من الذات الشاعرة، وترسم صور القصيدة من دماء الشاعر، ومشاعرها من مخاوفه، ومعانيها من آهاته، وأسئلتها من وقلقه، فيصبح الشاعر والقصيدة كلاهما غريبين في عالم تسوده الوحشة والوحدة والخيبة. يقول:
صَدِّقوني/ أنا لا أكْتُب/ تَرْقُصُ أصابِعي/ مَعَ الْحُروفِ/ في مِياه الدَّهْشَةِ/ كَيْ تَنْمو مَشاتِلُ الْمَعْنى/ في رُبوعِ الْبَياضْ.
- التنافر الفكري/ الوجود والعدم:
وتعد ثنائية الموت والحياة التي تندرج في ثنائية أشمل هي الوجود والعدم من أوجه التنافر الفكري في الديوان، ففي ضوئها تنعدم الفواصل بين العالمين، ويصبح التفاعل بينهما سمة مميزة لمنطوق الشاعر. ومن مظاهر التنافر على هذا المستوى خيبة أمل الشاعر في الآخر بمختلف أبعاده، الصحاب، والأصدقاء، والرفقاء، النخب، والجمعيات، والأحزاب. و"أغرب الغرباء من صار غريبا في وطنه". وإذ كان الشاعر يؤمن بأن الأصدقاء أخلاء فإذا هم في الواقع ينكرون الجميل ويجحدون النعم ويتخلون عن مبادئهم وعن بلدهم وأرضهم وأصلهم ومسقط رأسهم وفصلهم:
بِئْسَ الذينَ صادَقْتُهُمْ/ يوْماً باسْمِ الْبَلَدْ/ وما وَلَدْ/ وأنا ابْنُ كُلِّ الْأرْضِ/ وما وَجَدْ. ولعل القارئ يهتدي إلى أن الألم عند الشاعر محمد بلمو تيمة مركزية لا يستمدها من مرجعيات قبلية خارجة عن النص الشعري، ولا هي غريبة عن تجربته الخاصة، وإنما هي تابعة من المعاناة الذاتية، ولها عدة تجليات متنافرة، يلغي بعضها الآخر ويؤكده، كأن تنفي الحرية نقيضها (الأسر) كما ينفي الأسر نقيضه (الحرية)، فالسجن ألم، والعدم ألم، والإقصاء ألم، والظلم ألم، والتهميش ألم... فالإنسان الحر - من منظور الشاعر - أسيرٌ، والأسر حرٌّ، بحسب مفهوم الحرية الذي يختلف باختلاف السياق الذي يتحكم في توظيفه، ومن ثمة فالحياة إما أن تتحقق بشروطها وإلا فهي عدم واحتمال؛ (أحرار ≠ سجون) ≠ (عبيد ≠ طلقاء). يقول الشاعر:
أنْتُم الأحرارُ/ في سُجونِ الْجَلادينَ/ ونَحْنُ عبيدٌ طُلقاءُ/ فَوْقَ الْأرْضِ/ يَنْهَشُ لَحْمَها/ النَّدَمْ.
وعلى الرغم من أن الحزن يخيم على جل نصوص الديوان- بحيث يشكل تيمة محورية، لا يحضر نقيضها إلا من أجل البرهنة على الغياب - فإن هيمنة السواد على البياض، على ضآلته يزعج الظلام: ضوء ضئيل/ يزعج الظلام. وفق هذه الرؤيا يغدو الضوء مزعجا على قلته، والظلمة مهدّدة على قوة سوادها. وهذا لا ينفي تأكيد الشاعر على المعاني الإيجابية منها الحلم والصبر واليقين، ففي نص (الأمل.. لا يموت) ينَبِّر الشاعر على معاني الأمل، وهي كلمة محورية تتكرر أربع عشرة مرة، بحسب عدد المقاطع الشعرية، وفي بداية كل مقطع يتجدد ترديدها لتفيد التأكيد والتقرير. وقد عبر الشاعر عن المدلول الشعري نفسه بصيغة الإثبات وصيغة النفي. يقول:
- الأمل/ يحبو في صَدري/ يرقص في شعري.
- الأمل/ لا يموت/ أبدا/ لا يموت.
وإذا كان " الحزن قد صار محورا أساسيا في معظم ما يكتب الشعراء المعاصرون من قصائد" فإنه عند الشاعر يأخذ ميسما خاصا. إذ لا يملك الشاعر من مفر من الكمد إلا إليه، فينسج الحزن عنكبوته، عبر خيوط متشابكة تجعل الخلاص منه أمرا صعبا. والقصيدة المعاصرة تحمل طابع المأساة ووقع الفاجعة. بحيث يصبح الوجود عدما، ويظل كل ما كان يتمناه الشاعر ويأمل تحققه في طي الغياب، ولا يعكس زمن الحاضر إلا الخيبة. يقول في نص شعري تحت عنوان (بين قوس وقوس) في متوالية شعرية تشكل لازمة تتكرر عدة مرات:
كَأنَّ يَدي لَيْسَتْ/ يَدي/ والْأصابِعُ رَمْلٌ/ كَأنّي لَسْتُ/ أنا/ والسَّماءُ حَمْقاءُ.
يلج الشاعر إلى عالم الاحتمال والشك من باب عالم الحقيقة واليقين، موظفا أسلوبا بلاغيا، ومن منظور تخييلي قائم على المشابهة والتوقع (كأن)، وبموجبه تصبح الصورة قائمة على الانشطار والانفطار بين طرفي المشابهة:
- أنا (اليقين) ~ لست أنا (الاحتمال).
- يدي (اليقين) ~ ليست يدي (الاحتمال).
- السماء (اليقين) ~ السماء حمقاء (الاحتمال).
ففي هذا النص، ومن خلال هذا المقطع، يتجلى أن من الخيوط المؤلفة لنسيج المدلول الدال على الوجود والعدم خيطا أبيض دالا على الحقيقة وخيطا أسود دالا على الاحتمال، والملاحظ أن الشاعر يؤشر على هذه الدلالة التأويلية استنادا إلى مقومات فنية، منها كونه لم يقل في ملفوظ الكلام المؤطر لعنوان هذا النص (بين قوسين) بل قال (بين قوس وقوس)، مما يدل على أن الأول على نقيض الثاني، لذا تجنب استعمال المثنى، وجعل القوس الثاني ساكنا على خلاف الأول.
واستنادا إلى ما سبق، يتضح من أهم تجليات التنافر الدلالي الأسلوبي واللغوي أن يُنسب النعت لغير منعوته، والصفة لغير موصوفها، والمقصود من وراء ذلك أن تقوم العلاقة بين الطرفين على التنافر، مما يتطلب تشييد دلالة قائمة على التأويل، فما يقتضي الحزن يفرح، وما يقتضي الفرح يحزن، وما يتطلب الاعتبار يُهمَّش، وما يقتضي التهميش يتوَّج، وهكذا تتبدّى حقيقة الأشياء، في عالم عمه الشك والظلم والظلام، وغاب عنه العدل والأمن والسلام:
أنا الْآنَ عارٍ تمامًا/ مَطَرٌ/ ريحٌ/ وضَوْءٌ أقَلْ/ أضْحَكُ في وَجْهِ الْحُزْنِ الْمُرِّ/ حينَ يُتَوَّجُ الْخُبْتُ/ يَنْكَسِرُ الصَّفاءُ/ على إيقاعِ الْمُبْتَذَلْ.
والشاعر وهو يقيم رحلة العبور بين عالمين متنافرين، يسعى إلى البحث عن الوسائل الفنية التي تساعده على القبض على المنفلت في الزمان والمكان، ومن ثمة يستنفر أدواته وطاقته، فيرقى بالأسماء من مستوى الدلالة المباشرة إلى مستوى التأويل، وهو ديدن كل شاعر يسعى أن يَلُفّ نصوصه الشعرية بشيء من الغموض ليكسبها ثراء دلاليا وتأويليا، ومن هذه الأدوات الرمز الشعري، والشاعر محمد بلمو يجعل النص الشعري يصنع رمزه بدل أن يستدعيه من خارجه، وكمثال على ذلك (أريج) الاسم الذي يستعمله الشاعر رمزا في كثير من السياقات الشعرية ليصبح دالا دلالة مضاعفة. يقول:
مَنْ ذا الّذي لَمْ يُمْهِلْكِ/ أريجُ/ الْبَعيدَةُ/ وَراءَ الْقِمَمْ/ كَيْ يَسْقي ألَمي الْمُعَتَّقَّ/ الْأبَدِيَ/ بالمَزيدِ مِنَ الْألمْ/ كَيْ يَسيحَ دَمٌ آخَرْ/ بَريءٌ/ شَريدٌ/ شَهيدْ/ في شَوارِعِ الْأمَمْ.
يحاور الشاعر من باب الخيال "أريج" في عالم الغياب، فتحضر روحها ليحصل تفاعل عجيب بينهما، ولتنعدم الحدود الفاصلة بين الذوات- لأن ما يجمعها أقوى وأمتن وأعمق مما نتصوره في الواقع- بحيث تغدو "أريج" الرمز الذي ينظر الشاعر في ضوئه إلى عالمه الخاص والعام، فتنعكس صورتها الروحية شفافة ورهيفة تشع بالحقيقة والحكمة، وتنم عن الحلم والأمل، وترسخ قيم الثبات على المبدأ:
ما أبهاكِ صغيرتي/ لأنَّكِ مِثْلي/ لا تَهُزُّكِ ضَوْضاءُ الْوَقْتِ/ لا تُحَرِّكُ أهْدابَكِ/ أضْواءٌ فاقِعَةٌ/ خائِفَةٌ مِنْ حِكْمَةِ الْأزلْ.
يتبين أن توظيف التنافر على المستوى الشعري والفني يلزم أن يتم دون مبالغة، أي بقدر محدد، لكي يؤدي وظيفته الجمالية، ولكي لا يصبح غاية في حد ذاته، كما حدث مع كثير من التجارب الشعرية المعاصرة الموغلة في التجريب، ولذلك فالشاعر يتحرى الدقة في اعتماده، وفق طرق فنية تجعل النص الشعري متأرجحا بين الغموض والوضوح .
التنافر الفني/ التثبيت والنفي:
كل الأمثلة المدرجة، سابقا ولاحقا، تعكس نوعا من التنافر الفني في الديوان، مما يؤكد أن الفصل بين مستويات التنافر أمر صعب، خاصة مع النصوص الشعرية؛ ويمكن أن يلاحظ القارئ هذا النوع على عدة مستويات فنية، تطال شكل النصوص ومضمونها، إذ يتبين أنه يصعب أن تؤطِّر نصوص المجموعة ضمن نمط محدد، وإن كانت الكتابة الشعرية تتميز عند الشاعر محمد بلمو بالانحسار، واعتماد نظام الأسطر الشعرية، بحيث تأتي ضامرة في الغالب. ذلك أن كثيرا من الشعراء يكتبون الشعر ويصدرون فيه عن صَنْعة، والقليل منهم من يكتبهم الشعر ويصدرون فيه عن طَبْع، والأقل منهم من يجمع بينهما.
ولعل الإيقاع الداخلي للنصوص الشعرية يعكس على مستوى انحسارها واختزالها الحالة النفسية المتأزمة للذات الشاعرة، إذ يؤشر على الانكسار على مستوى البنية الصوتية للمتوالية الشعرية. والانكسار نفي لإثبات شيء معين. وهو ما يكشف عن ذات حزينة، تتلفظ الكلمات على شكل زفرات حرى وأصوات متقطعة. كما نجد الشاعر يوزع الجملة الواحدة على عدة أسطر ليؤشر على الانكسار، حتى ولو كان ملفوظا شعريا دالا على الأمل أو الحلم أو الفرح. فالشاعر مثلا يكتب الجملة بشكل عمودي ويكتفي بكلمة واحدة في كل سطر، مما يعرب عن الرغبة في تكسير السطر على الرغم من تمحور مدلوله الشعري حول معني إيجابي. كما أن الكتابة وفق هذا التشكيل الشجري تحيل على رمز الشجرة التي لا تموت إلا واقفة. ونزعة القلق أو الشقاء تنتهي إلى يأس من الإنسان والحضارة، أو إلى الإيمان بالبعث والتجدد:
أدْفِنُني واقِفاً/ مِثْلَ شَجَرَةْ/ أغْرِسُ الْبَحْرَ في جَبْهَتي/ والزَّعْتَرَ في قَدمي/ وفَوْقَ رَأسْي قُبَّرَةْ.
إلا أن هذا لا ينفي أن الأسطر الشعرية قد تأتي ممتدة مع بعض القصائد، وهي حالة خاصة تعكس تنافرا بنائيا، إذ يتبين أن الدفقات الشعرية الممتدة قد تدل أيضا على نفسية مكلومة، وكأن الشاعر يتعمد أن يكسر المتعارف عليه من خلال خلق تنافر بين الشكل والمضمون. فمن النصوص الممتلئة الأسطر في الديوان نص (لن توقفوا ناركم) الذي ينتهي بشكل مخالف عن بدايته، مما يعكس تنافرا على مستوى الشكل الفني للنص الشعري، وما يعضد هذا التنافر كون الشاعر عمد إلى كتابة متوالية العنوان في نهاية النص بطريقة عمودية بعد أن استهل بها النص أفقية. وعلى هذا الأساس يصبح معنى الجملة الواحدة مختلفا باختلاف شكل الكتابة بين النفي والإثبات:
- لن توقفوا ناركم. (أفقي) المستقبل (معنى طوعي).
- لم/ توقفوا/ ناركم. (عمودي) الماضي (معنى قسري).
وجاء البناء الفني لنص (أيها الأحزان مهلا) على نظام السطر الشعري المنحسر، بحيث أبى الشاعر إلا أن يضع كل مفردة في سطر مستقل في الغالب الأعم، وهو ما يقتضي من القارئ قراءة النص قراءة عمودية كلمة كلمة من الأعلى إلى الأسفل، إلا أن هذا التوزيع لا ينفي ارتباط الألفاظ ببعضها لتشكل متوالية شعرية ممتدة، وعلى الرغم من دلالة هذا التشظي فإن المدلول الشعري يعكس نوعا من الثبات على المبدأ، يقول الشاعر:
تَموتُ/ واقِفَةً/ أشْجاري/ تَقولُ/ لِلنَّتانَةِ/ لِلنَّذالَةِ/ لِلْعُنْفِ/ الْمُتَنَطِّعِ/ اِرْحَلْ/ مِنْ قَراري/ اِرْحَلْ/ مِنْ خِياري/ اِرْحَلْ/ مِنْ دِياري/ اِرْحَلْ/ مِنْ لَيْلي/ ونَهاري.
يريد الشاعر لحروفه أن تكون مدمرة من نحو، وأن تكون بانية من نحو آخر؛ صاعقة في وجه الظلم والظلام، فيصورها تنبعث منها رائحة البارود، لأن تجار السلام والكلام يشعلون نيران الحروب بين الشعوب والأمم، ويدسون الدسائس بين البلدان، ها هنا تعكس ثنائية السلم والحرب تنافرا بين التثبيت والنفي، بين الموقف والسلوك، بين القول والفعل، وبين ما يدعيه هؤلاء وما يكرسونه على أرض الواقع، وكأن الشاعر يأبى إلا أن يكشف عن المؤامرة والمكائد التي تثيرها الدول العظمى - وما هي بعظيمة في شيء- في العالم أجمع. إن حزن الشاعر في ضوء هذا يبدو أعم وأشمل مما يتصور، لأن كرنفالات المواجع تتجاوز الذات، وتتوالى عبر الزمان وفي كل مكان:
صَدِّقوني/ أنا لا أكْتُبُ/ أحاوِلُ أنْ أشْعِلَ الْقَلَقَ في الْقُضْبانِ/ والْخَوْفَ في الْقُيودِ/ والضَّوْءَ في الدَّهاليزِ/ الْمُقْفِرَة/ حينَ تَنْبَعِثُ مِنْ حُروفي/ رائِحَةُ الْبارودِ/ نيرانُ الْمَدافِعْ/ لِأنَّ تُجّأرَ الْحَروبِ/ لا يُريدونَ للسَّلامِ/ أنْ يَحُطَّ يَوْماً عَلى هَذه الْأرْضْ.
التنافر على مستوى اللغة الشعرية يبرر في تفاعل التصريح والتلميح تفاعلا قويا، فالتصريح إقرار وتأكيد وتثبيت لمعنى مقصود، والتلميح نفي وتجاوز وعُدول عن المعنى المباشر غير المقصود؛ وفي الشعر لا تحضر التقريرية كسمة أسلوبية نثرية إلا بنسبة ضئيلة حتى لا تهيمن هيمنة تفقد النص شعريته، غير أننا ملزمون كقراء أن نتحرى الدقة في الحكم، فكثير من الأساليب التي قد تبدو في ظاهرها تقريرية هي في العمق على خلاف ذلك، تبعا للموقف المعبَّر عنه، والسياق المقامي والمقالي الذي يؤطر القول الشعري، فقد يَصْدُرُ الشاعر عن موقف ساخر في قول تقريري محدد فيراد به خلاف بل نقيض ما يعنيه، وهو ما يمثل تنافرا دلاليا. يقول مثلا:
أنا لازِلْتُ أنْتَظِرُ قُدومَكِ/ لِدِياري الهالِكَةِ/ في أعْلى الْجَبَلْ.
قد يبدو المقطع دالا دلالة مباشرة على معناه القريب؛ فالشاعر يقر برغبته الأكيدة في انتظار المعنية بالخطاب (أريج) وإن طال الزمن وشطّ المزار وحالت دون ذلك عوائق؛ منها قدم مكان اللقاء الموعود (الديار الهالكة) وصعوبة الوصول إليه (أعلى الجبل)، لكن المعنى البعيد والمضمر يتنافر مع السابق ذلك أن عودة أريج مستحيلة، لأنها غابت عن الدنيا، والشاعر يدرك ذلك تمام الادراك، لكنه يريد أن يؤكد أن هذه العلاقة تعلو على الواقعي وتعتنق المتخيل، ولأن روح "أريج" تسكن قلبه ووجدانه وعقله لذا يجعل منها الشاعر رمزا شعريا يؤثث رؤاه ويوقظ أشجانه، لتحيل على صباه وجذوره ومسقط رأسه، في أعلى الجبل (قصبة بني عمار بزرهون ناحية مكناس المغرب) ومدى الإهمال الذي طال المكان، فأصبح أطلالا، وأثرا بعد عين. إن الشاعر المفارق لمهجته " أريج" لا يقوى على التعبير إلا بالموسيقى الحزينة. ولعل توظيف أسلوب الالتفات في المقطع الشعري أعلاه - من حيث دلالته على الانتقال من زمن الحاضر إلى زمن المستقبل (قدومك) مع الالتفات إلى الماضي - يؤكد امتداد الشجن .
إن فعل الكتابة عند الشاعر محمد بلمو يحضر في بعده الدلالي التنافري، بمختلف تشكُّلاته الفكرية والفنية والجمالية، وبإمكان القارئ أن يلاحظ أن كثيرا من الشواهد الشعرية تصب في هذا المحور المعرفي، وتأتي في شكل علامات تكشف عن البنية الداخلية المؤطرة للنص الشعري التي تستند إلى قانون التفاعل الحركي الفعال بين شعور ولاشعور النص، بين الظاهر والباطن، بين المثبت والمنفي، بين البياض والسواد.
تبين إذن أن التنافر الدلالي في ديوان (طعنات في ظهر الهواء) مدخل من مداخل القراءة الممكنة، لكنه ليس المدخل الوحيد، وهو انعكاس للاشعور الشاعر، وظاهرة نصية وفنية مبررة أسلوبيا، على عدة مستويات تكوينية، حاولنا ملامسة أهما، واتضح أن النص الشعري في الديوان المقروء يصنع ديناميته من داخله بشكل حركي، وبطريقة عفوية لا تقوم على هندسة مسبقة لفعل الكتابة، مما يجعله سببا لا نتيجة، و معبرا لا منتهى، ووسيلة لا غاية. والقارئ مطالب، بين هذا وذاك، بأن يشيِّد فهمَه في ضوء هذا المعطى، كما بإمكانه أن يعتمد منظورات مغايرة ومخالفة لما جنحنا له.
هـــوامــش: